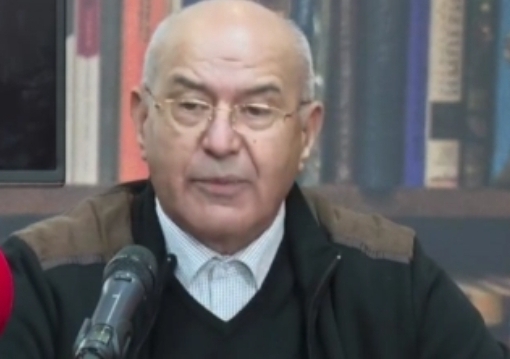القانون جزء من الإصلاح وقد يشكل في اللحظات الكبرى موجها له خاصة إذا كان يرتكز على رؤية استشرافية. كان هذا واقع إصلاح التعليم العالي بالمغرب سنة 2000 عندما تم وضع قانون التعليم العالي 01.00، واليوم يوجد مشروع جديد لتغيير هذا القانون تمت المصادقة عليه مؤخرا من طرف الحكومة تحت عدد 59.24. وهو يشكل محطة مهمة في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ببلادنا. نناقش في هذا المقال المشروع الجديد من ثلاث زوايا: أولا مقارنته مع القانون الإطار 51.17، ثانيا مقارنته مع القانون 01.00 الذي لا زال ساري المفعول، وثالثا مقارنته مع المعايير الدولية للتعليم العالي والبحث العلمي.
أولاً: المقارنة مع القانون الإطار 51.17
مشروع القانون 59.24، رغم كونه وثيقة تشريعية متقدمة وطموحة تحاول تفعيل القانون الإطار، إلا أنه يعاني من ثغرات مهمة ونقاط تعارض مع القانون الإطار الذي يفترض أن يمتثل له، خاصة فيما يتعلق بالتجميع الهيكلي لمكونات ما بعد الباكالوريا، ومكانة اللغة العربية كلغة أساسية للتدريس، والموازنة بين تشجيع القطاع الخاص وضمان تكافؤ الفرص والحد من التفاوتات. وهكذا يحافظ المشروع على الوضع القائم المجزأ بدلاً من السير نحو التجميع الذي يعتبره القانون الإطار أساساً لإعادة الهيكلة، مما قد يضعف تحقيق مبادئ التناسق والتكامل والفعالية التي أرستها المادة 12 من القانون الإطار. ورغم أن هذا الأخير ينص على ضرورة اعتماد اللغة العربية كلغة أساسية للتدريس، وترسيخ مكانة اللغة الأمازيغية، لغة رسمية للدولة وتراث مشترك لجميع المغاربة بدون استثناء، فإن مشروع القانون 59.24 بينما يؤكد على تعزيز مكانة اللغتين الرسميتين دون صيغة معيارية إجرائية، فإنه ينص على تنويع لغات التدريس وتشجيع استعمال اللغات الأجنبية الأكثر تداولاً. أما التعليم الخاص فيبدو أنه استفاد من وضعية تفضيلية تتناقض مع مبدأ التوازن مع التعليم العمومي الذي أرساه القانون الإطار، بحيث أن مشروع القانون 59.24 يشجع بشكل لافت للانتباه على تطوير التعليم العالي الخاص من خلال حذف مرحلة الاعتراف والاكتفاء بمرحلتي الترخيص والاعتماد، وإحداث المؤسسات غير الربحية ذات النفع العام التي تستفيد من الشراكة مع الدولة، والتمكين من إحداث جامعات فقط بمرسوم في حين أن الجامعات العمومية تحدث بقانون. وفي حين يمكن الدفاع عن أن تنويع العرض يخدم « تكافؤ الفرص » بمعنى توفير خيارات أكثر، إلا أن هناك خطراً حقيقياً يتمثل في إضعاف المرفق العمومي إذا أدى التوسع في القطاع الخاص إلى استنزاف الكفاءات والموارد من الجامعات العمومية، وتكريس التفاوت المجالي والاجتماعي إذا تركز التعليم الخاص الجيد في المدن الكبرى وبأسعار لا تستطيعها جميع الفئات، مما يعمق الفجوات. بالإضافة إلى التأسيس لنظام بسرعتين يكون فيه التعليم العمومي للعامة والتعليم الخاص للنخبة، مما ينتهك مبدأ تكافؤ الفرص في الجودة. وما يثير أكثر هذه المخاوف هو أن المشروع لم يقدم ضمانات قوية كافية لمواجهة هذا الخطر، مثل وضع آليات صارمة لتحقيق التوازن بين القطاع الخاص والقطاع العامة فيما يتعلق بجودة التعلمات.
نقط أخرى يبدو أنها تختلف بين القانون الإطار والمشروع الجديد وهي المتعلقة باستقلالية الجامعات وبتدبير الموارد البشرية وبالحكامة الترابية. فالقانون الإطار يدعو إلى تعزيز الاستقلالية الفعالة للجامعات في إطار تعاقدي، بالمقابل ينص مشروع القانون 59.24 على إنشاء « مجلس أمناء » كجهاز جديد فوق مجلس الجامعة. وعلى الرغم من أن فكرة « مجلس الأمناء » بحد ذاتها ليست سيئة، بل يمكن أن تكون أداة للدعم الاستراتيجي. لكن التركيبة المقترحة تثير تساؤلات جدية حول طبيعة الاستقلالية. إذ أن سيطرة التمثيل الحكومي والأطراف الخارجية، وهيمنة آلية التعيين على آلية الانتخاب يثير مخاوف حول إمكانية تحكم هذا المجلس في القرارات المصيرية للجامعة خاصة في ظل الصلاحيات الاستراتيجية التي يتمتع بها، مثل المصادقة على الاستراتيجية متعددة السنوات، وتقييم أداء الجامعة، وتتبع تنفيذ العقود-البرامج مع الدولة، وتتبع تنفيذ توصيات التقييم المؤسساتي، والمصادقة على اتفاقيات إحداث الأقطاب الجامعية. وهو ما يعني أن نموذج « مجلس الأمناء » يشيد شكلاً جديداً من الوصاية المستمرة والمباشرة على الجامعة ويؤسس لتحول واضح من « الوصاية العمودية » إلى « الوصاية الأفقية » من داخل الهيكلة الجامعية نفسها. قد يكون هذا تقييداً للاستقلالية الفعلية للجامعة تحت غطاء « الحكامة الحديثة ».
أما في محور تدبير الموارد البشرية فإن القانون الإطار يلزم بإعداد دلائل مرجعية للوظائف والكفاءات… تؤخذ بعين الاعتبار في إسناد المسؤوليات البيداغوجية والعلمية والإدارية وكذلك في تقييم الأداء والترقية المهنية. لكن مشروع القانون 59.24 يكتفي بالنص على أن « الموارد البشرية العاملة بمؤسسات التعليم العالي التابعة للقطاع العام تتكون من الأساتذة الباحثين المحددة وضعيتهم النظامية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. » هذا التوجه يقر بأن الأستاذ الباحث ينتمي إلى الوظيفة العمومية أكثر من انتمائه للجامعة التي يعمل بها. ولا يربط تقييم الأستاذ الباحث وتقدمه المهني بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة أو بجودة التدريس أو بمدى إسهامه في نجاح الطلبة أو في تطوير البحث العلمي والابتكار. وبدون ربط مصير الأستاذ الباحث بمصير جامعته، تظل استقلالية الجامعات مجرد هيكل إداري أجوف، لأنها لا تملك أهم أدواتها أي فريق العمل الملتزم بمشروعها.
من جهة أخرى، يوجب القانون الإطار مواصلة سياسة اللامركزية واللاتمركز في تدبير المنظومة على المستوى الترابي وتفعيل مبدأ التفريع، غير أن مشروع القانون 59.24 غيب هذا المقتضى أو قاربه بطريقة شكلية. فالمشروع يتحدث عن العدالة المجالية لكنه لا يقدم آليات حقيقية لتدبير التعليم العالي على المستوى الجهوي بحيث لا نجد ذكرا لدور فعال للأكاديميات الجهوية أو للجماعات الترابية في التخطيط أو التدبير. كما أن القرار ظل ممركزا في الغالب إذ أن إحداث الجامعات يكون بقانون، وإحداث المؤسسات الجامعية بمرسوم، وحتى الأقطاب الجامعية تحتاج لتصديق من السلطة الحكومية. ورغم أن التمثيل في مجلس الأمناء يضم رئيس مجلس الجهة وفي مجلس الجامعة رئيس مجلس العمالة أو الإقليم، لكن هذا يبقى تمثيلاً استشارياً في جهاز تدبير مركزي الطابع، وليس تفويضاً للسلطات. ومن هذا الجانب فإن المشروع يرسخ النموذج المركزي لتدبير الجامعة ولا يعمل على استشراف حكامة ترابية حقيقية للتعليم العالي تجعله في خدمة التنمية الجهوية.
أما في الجانب البيداغوجي الذي يعتبر قطب الرحى لأي قانون يوجه وينظم التعليم العالي فإن الهوة مع القانون الإطار تبدو سحيقة. إذ أن مشروع القانون 59.24 همش تماما الآلية المؤسساتية لإعداد البرامج والتكوينات ألا وهي اللجنة الدائمة للمناهج، فهو فقط يشير في باب التنظيم البيداغوجي إلى قواعد عامة وهندسة بيداغوجية لكن دون تحديد الجهة المؤسساتية المسؤولة عن تطويرها وتحيينها بشكل نسقي ومستمر. القانون الإطار أكد على أن إصلاح المناهج ليس حدثاً ظرفيا بل عملية مستمرة تحتاج لهيكل دائم. مشروع القانون ترك هذا الأمر غامضاً، مما يجعله رهين قرارات وزارية ظرفية وغير مستقرة، ويُفقد الإصلاح البيداغوجي استمراريته. من جهة أخرى ينص القانون الإطار على العمل بإطار وطني مرجعي للإشهاد والتصديق تدبره هيئة مستقلة، لكن مشروع القانون 59.24 حتى وهو يذكر الشهادات الوطنية واعتماد مسالك التكوين لا يرى داعيا لذكر للإطار الوطني المرجعي للإشهاد الذي يعتبر العمود الفقري لضمان جودة الشهادات وقابليتها للمقارنة وتوافقها مع حاجات الاقتصاد. غيابه من المشروع يترك الباب مفتوحاً لتفاوت كبير في قيمة الشهادات بين المسالك والمؤسسات، ويضعف مصداقية المنظومة ككل. وفي باب التقييم الذي له صلة بهذا الموضوع فإن مشروع القانون 59.24 اقتصر على عموميات حول تحصيل الوحدات الدراسية عن طريق التقييم المنتظم وتفادى أي تفصيل بخصوص إصلاح نظام التقييم الذي يعتبر ركيزة أي تغيير بيداغوجي حقيقي. رغم أن إصلاح التقييم هو مفتاح إصلاح التعليم العالي، وترك هذا الجانب غامضاً يعني أن النموذج البيداغوجي القديم القائم على الحفظ والامتحانات الإقصائية سيواصل هيمنته، مما يفشل أي محاولة لتطوير الكفايات والتفكير النقدي.
أيضا ركز القانون الإطار على مسألة التكوين الأساس كشرط ضروري لممارسة مهنة التدريس وأهمية المقاربة التشاركية في ضمان انخراط العنصر البشري في تفعيل الإصلاح فهل عكس مشروع القانون هذه التوجهات؟
ينص القانون الإطار صراحة على اعتبار التكوين الأساس شرطا ضروريا لمزاولة مهام التدريس والتأطير، غير أن مشروع القانون 59.24 لا يشترط أي تكوين أساس لممارسة مهنة الأستاذ الباحث، وعندما يعرض إلى شروط الترخيص للمؤسسات الخاصة فإنه يشترط أن تتوفر على هيئة قارة للتدريس تكون أغلبية أعضائها حاصلين على الدكتوراه أو ما يعادلها، مما يعني بالنسبة للمشروع أن الإلمام بالتخصص (الدكتوراه) يكفي للتدريس في التعليم العالي، دون الحاجة إلى التكوين على المهارات البيداغوجية. هذا يتعارض مع القانون الإطار الذي يريد تجديد مهن التدريس، ومع المنطق التربوي الذي يفيد بأن الخبرة في مجال معرفي لا يعني تلقائياً القدرة على نقل المعرفة بشكل فعال. مهارات التدريس، والتقييم، وتيسير التعلم هي كفاءات تحتاج إلى تكوين خاص. وقد أكدت العديد من الدراسات بأن أحد أسباب ضعف جودة التعلم في الجامعات يرجع إلى عدم تكوين الأساتذة الباحثين على البيداغوجيا الجامعية. وهكذا فإن المشروع أهمل تماماً فرصة إدخال شرط الحصول على شهادة في البيداغوجيا الجامعية أو اجتياز تكوين أساسي كشرط للتوظيف أو الترقية، مما يكرس النموذج القائم على « العالم الباحث » فقط وليس « الأستاذ المكون ».
وإذا كان القانون الإطار يؤسس لفلسفة تشاركية واضحة تتحقق في إطار التزام جميع المتدخلين… على أساس ربط الحقوق بالواجبات التي يحددها ميثاق تعاقدي لأخلاقيات المهن، فإن مشروع القانون 59.24 يغلب عليه الطابع التقني-الإداري، بحيث أن آليات التشارك ضعيفة أو شكلية وتفضل نمط التعيين على الانتخاب، والميثاق التعاقدي لأخلاقيات مهن التعليم العالي غير منصوص عليه. وبذلك فإن المشروع يفوت فرصة تاريخية لبناء شرعية واسعة للإصلاح، لأن بإهماله البعد التشاركي، فإنه يغذي النزعة التقليدية التي تنظر إلى الإصلاح على أنه قرار مفروض من الأعلى، ويضعف الانخراط لأنه عندما لا يشعر الفاعلون الرئيسيون والأساتذة الباحثون على وجه الخصوص أنهم شركاء في التغيير، فإن مقاومتهم له قد تزيد، مما يعيق تنفيذه على الأرض.
خلاصة هذه المقارنة مع القانون الإطار تفيد بأن مشروع القانون 59.24 هو مشروع إصلاحي طموح من حيث الهيكلة الإدارية والطموح البحثي، لكنه يعاني من قصور عميق على مستوى الفلسفة الناظمة والمقاربة الإصلاحية. فهو يركز على « الوعاء » ويغفل « المحتوى » عندما يهتم مثلا بإنشاء الأقطاب والهياكل لكنه يهمل آليات إصلاح المناهج ونظام التقييم، والإشهاد. وهو يعالج الأعراض ويترك الأسباب عندما يحاول تحسين الأداء دون معالجة السبب الجذري، وهو نظام تدبير الموارد البشرية غير المرتبط بالأداء المؤسساتي وغياب التكوين البيداغوجي الأساسي. وهو يعلن اللامركزية ويرسخ المركزية من خلال إهمال البعد الترابي وتعزيز وصاية مجلس الأمناء. وهو يتغنى بالجودة ويغفل أدواتها الأساسية بعدم اشتراط التكوين الأساس وإهمال البعد التشاركي.
وبالتالي فإن المشروع في وضعه الحالي يضفي الشرعية على استمرارية الوضع القائم تحت غطاء من المصطلحات الإصلاحية الحديثة (استقلالية، جودة، أقطاب…). مما قد يؤدي إلى إصلاح شكلي لا يمس جوهر المشاكل المزمنة للمنظومة.
في الجزء الثاني من هذا المقال نتطرق إلى مقارنة المشروع مع القانون 01.00.